فتحي عبدالسميع: الشعر عاجز أمام الطوفان الاستهلاكي والتفاهة
• «حياتنا مملوءة باللغة الرمزية التي لا نشعر برموزها في أحيان كثيرة»
• وُلدتَ في قرية نجع عزوز بمحافظة قنا بصعيد مصر، كيف أثّرت هذه البيئة في تكوينك الشعري ورؤيتك للحياة؟
- تؤدي الجغرافيا دوراً كبيراً في كينونتنا، لا نشعر به غالبا، لكننا في النهاية أبناء البيئة التي وُلدنا فيها، وقد تميّزت بيئتي في أقصى الصعيد باحتوائها على الجبل وعوالمه، إضافة إلى الحقول ونهر النيل وعوالمه، فجمعتُ بين ليونة الماء وحدّة الصخور، وتسلّل هذا إلى لغتي الشعرية وعوالمي الفنية ومواقفي الفكرية، ولا أستطيع فصل الجغرافيا عن الناس الذين تأثروا بالموقع الجغرافي، خاصة مع بُعده عن العاصمة في ظل حكومة مركزية عميقة الجذور، كانت تركِّز على العاصمة وتهتم بها على حساب الأطراف النائية، وكثيراً ما ظهر هؤلاء الناس بمشكلاتهم وموروثاتهم الشعبية في قصائدي وأضافوا لي تفرّداً وتميزاً بقدر ما منحتهم من إصغاء واحترام.

• متى بدأت علاقتك الأولى بالشعر؟
- لا توجد بداية واحدة، توجد بدايات، أولاها في مرحلة المراهقة، وهي بداية غريزية في تقديري، لأنّ الشعر رمز من رموز الخصوبة، وطقس من طقوس الغزل، وكل إنسان بداخله شاعر، قد تسمح الظروف بتفتح موهبته، وقد يظل حلمه حبيساً في أعماقه، وقد يتحقق في محبة الشعر والشعراء، وأهم بداية لي كانت مع انتفاضة أطفال الحجارة في فلسطين الحبيبة عام 1987، وكان حدثا جللا، تأثّرت به مثل كل عربي، وكتبت قصيدة تلقائية أعبّر فيها عن غضبي وشعوري بالعجز والعار، وهذه القصيدة أعجب بها جاري الشاعر محمود مغربي، الذي أخذني إلى شاعرين كبيرين في مدينة قنا، هما سيد عبدالعاطي، وعطية حسن، وفي بيتهما تعلّمت الكثير ووضعتُ أقدامي على الطريق الصحيح، والثلاثة لهم الفضل في كل ما وصلت إليه.
الجوائز مفيدة جداً حيث يشعر المبدع بالتقدير وترتفع قيمته الاجتماعية
• كيف تنظر إلى تجربة النشأة في الصعيد وتأثيرها على الأدب والشعر؟
- تجربة صعبة ومحبطة جداً، وتأثيرها سلبي، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها غياب المناخ الذي يسمح بتفتُّح المواهب الإبداعية، كل المواهب كانت تهاجر إلى القاهرة وتستقر هناك، كما هي الحال مع أمل دنقل وعبدالرحمن الأبنودي، على سبيل المثال.
كان تعامُل الحياة الثقافية في القاهرة قاسيا معنا، حيث كان يُنظر إلينا دائما كشعراء أقاليم، ثقافتهم ضعيفة ولا يمكن دمجهم في «شلّة» ثقافية، أو الاستفادة منهم بشيء.
• أصدرت العديد من الدواوين الشعرية، بدءًا من «الخيط في يدي» عام 1997، وصولًا إلى «عظامي شفافة وهذا يكفي» عام 2022، كيف ترى تطوّر تجربتك الشعرية خلال هذه السنوات؟
- لم أكن راضيا في أي وقت من الأوقات بما أنجزته على المستويين الجمالي والمعرفي، قصيدتي كانت متمردة على نفسها وتكره التكرار، كلما ذهبتْ إلى مكان غادرتْه بحثاً عن مكان جديد، لأنّ التجارب المكررة لا تعني شيئا، بعض الشعراء يفرحون بشعرهم، فتقف تجاربهم في موضع ثابت، تتحرك على مستوى الكم وتتجمد على مستوى الكيف.
الشعر لا يحسب بالكمّ، بل بالتجارب المختلفة التي تكتشف ما بداخلنا من ثراء لا حدود له، هذا المعيار كان في ذهني دائما، ولهذا اختلفت تجاربي عن بعضها اختلافا شديدا، وفي النهاية، القارئ البصير هو الذي يحكم على ما تتمتع به تجربتي من تطوّر. وحتى هذه اللحظة لست راضيا عن تجربتي الشعرية، وأتمنى أن أضيف إليها قصائد أخرى، توسعها وتعمقها ولا تخنقها.
• عناوين دواوينك تحمل رمزية عميقة، مثل فراشة في الدخان، وتمثال رملي، والموتى يقفزون من النافذة، إلى أيّ مدى تهتم بالبُعد الرمزي في قصائدك؟
- الإنسان كائن رمزي، وهذا ما يميّزه عن الحيوانات، ولولا الرموز ما عرفنا الحضارة، وحياتنا مملوءة باللغة الرمزية التي لا نشعر برموزها في أحيان كثيرة، ولهذا كان الرمز مفتاحا لتجربتي الشعرية والفكرية معا، لأنني في دراستي لطقوس الثأر، أو علاقة السّيَر الشعبية بالأساطير القديمة، أدرس الرموز في المقام الأول، كتابي عن الثأر كتاب عن الرمزية، ودراستي عن التراث الخفي دراسة في الرمزية، لا يمكن أن نتجاوز القشرة الخارجية أو السطحية للعالم دون أن نحيا في عالم الرموز.
• ما الدوافع التي تجعلك تستمر في كتابة الشعر، رغم التحولات الثقافية والإعلامية التي قد تُبعد الجمهور عن القصيدة، كأن يقال مثلا إننا في عصر الرواية؟
- الشعر والعمل الثقافي عموما بالنسبة لي رسالة، ويجب أن أقوم بها، بغضّ النظر عن أي شيء آخر، قيمتي في رسالتي، وهذه القيمة أشعر بجمالها في روحي، وأضحّي من أجلها بسهولة، لا يمكن الحكم على تجربتي من خلال المنطق العام للأمور في هذا العالم، حيث الربح هو الإله، والاستهلاك هو الجنّة، تجربتي مضادة لهذا المنطق الذي ينظر للإنسان نظرة سطحية.
الشعر لا يُحسب بالكم بل بالتجارب المختلفة
• إلى جانب كونك شاعرًا، لديك حضور نقدي بارز في الأدب والعلوم الاجتماعية، كيف توازن بين الإبداع الشعري والرؤية النقدية؟
- أترك نفسي في البحر وأسبح، أحبّ الشعر أكثر من أي جنس أدبي أو فكري آخر، لكنني عاجز عن صنع التوازن، تجاربي البحثية تأخذ من تجربتي الشعرية، ولا أعرف كيف أتوقف، أشعر أن رسالتي في الشعر هي رسالتي في الدرس والبحث والتنقيب، وفي أعماقي أتمنى لو توقفت عن كل شيء، واكتفيت بعشقي للشعر قراءة وكتابة.
• حصلتَ على العديد من الجوائز المهمة، كيف ترى دور الجوائز العربية في تحفيز الإبداع والاعتراف بالتجارب الأدبية الجديدة؟
- جائزة المبدع في إبداعه، هذا الإبداع في حد ذاته جائزة كبرى ومنحة إلهية عظيمة، والمبدع الحقيقي هو الذي يهتم بهذه الجائزة التي تمنحه متعةً داخلية فريدة لا يحققها شيء آخر، وتبقى الجوائز أمرا ثانويا، وهناك أدباء كبار جدا لم يحصلوا على جوائز، واستمر عطاؤهم ودخل في تكوين المبدعين الجدد، وأهم الجوائز بعد الإبداع هي وجود إنسان يحترمك كمبدع ويحترم تجربتك، وهو لا يعرف عنك شيئا ولا تربطه بك أي مصلحة، وهذا لا يعني أن جوائز المؤسسات لا تعني شيئا، بل هي مفيدة جدا، حيث يشعر المبدع بالتقدير، وترتفع قيمته الاجتماعية باعتراف المؤسسات بكفاحه، وتزيد فرص انتشاره بسبب الضوء الإعلامي الذي يصاحب الجوائز عادة.
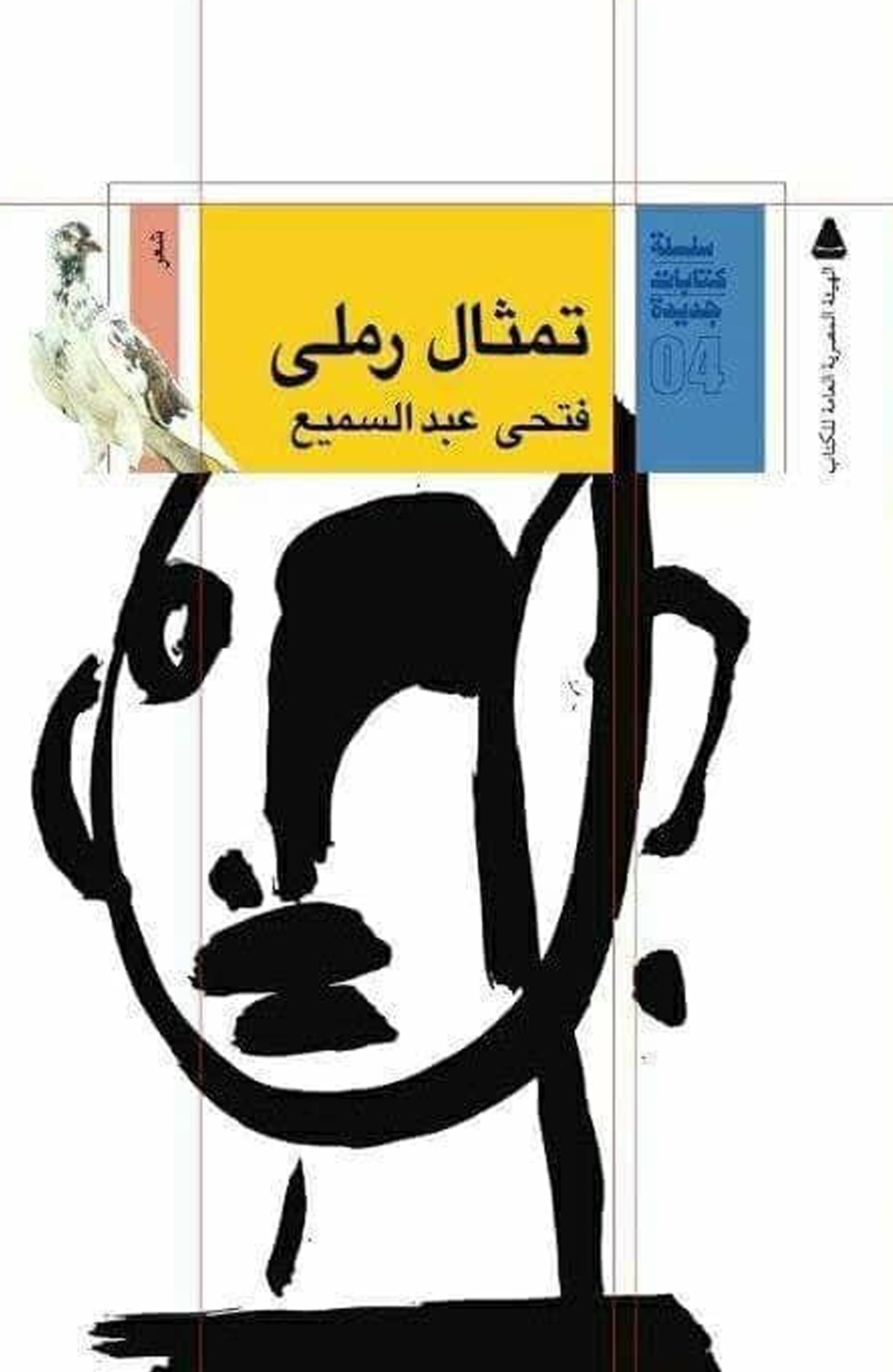
• كيف تقيّم حال المشهد الشعري العربي اليوم؟ وهل تعتقد أن الشعر ما زال قادرًا على التأثير في الوعي العام كما كان في الماضي؟
- الشعر بخير، لكن العالم ليس على ما يُرام، الشعر الجيد كثير في بلادنا، لكنه عاجز هذه الأيام بسبب الطوفان الاستهلاكي الذي يجتاح العالم، والتفاهة التي تهيمن وتدفع كل شيء حقيقي بعيدا عن مكانه المناسب، الشعر يتعرّض للتهميش الشديد، من خلال ضعف المؤسسات الجامعية وعجزها عن تعميق علاقة الطلاب بالشعر، بل وتقوم بتنفيرهم منه، وهو يتعرض للتشويه من خلال الخطاب الإعلامي والأعمال الدرامية، كل هذا ـ وغيره ـ يؤدي إلى تهميش دور الشعر في المجتمع، لكن هذا التهميش لا يمكن أن يدوم.
• لديك العديد من الكتب تحت الطبع، هل يمكنك أن تكشف لنا عن مشاريعك الأدبية القادمة؟
- في حقل الشعر، لديّ ديوان جديد في المراجعة الأخيرة، وقد اخترت له عنوانا مؤقتا هو «العقرب وهو يجري»، وفي حقل الدراسات الاجتماعية أعمل في الجزء الثالث من موسوعتي عن ثقافة الثأر، وهذا الجزء سوف يكون بعنوان «نعش القتيل... الثأرُ والطقوس السحرية»، وفي حقل النقد الأدبي لديّ كتاب عن محمود درويش، كتبتُ بعض فصوله منذ فترة طويلة، وآمل استكماله في النصف الأول من العام المقبل بإذن الله.



